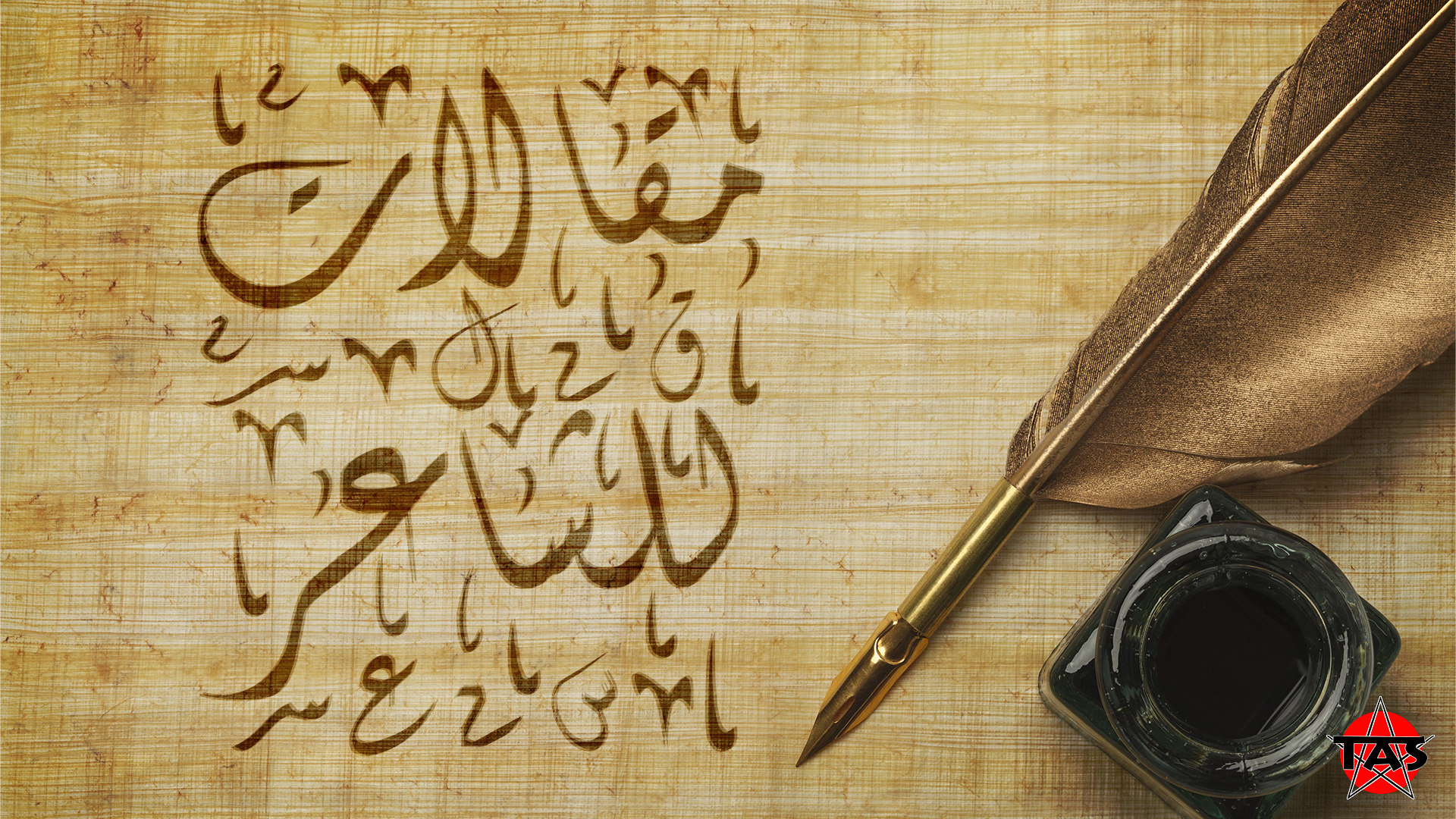د.جمال أبوسمرة
ليس من العسير على متلقي شعر أيمن أبي شعر في جلّ ما كتب، ولا سيّما مجموعته الشعريّة الأخيرة (سلاماً مواعيد قلبي دمشق)، أن يستحضر معه أدواته الثقافة علت أو انخفضت، بسيطة كانت أم مركّبة، سطحيّة أم عميقة، لأنّ الشاعر استطاع وبحرفية، أن يجعل من شعره طبقات متراكبة، تسلم قيادها الانفعالية بيسر وسهولة للجميع، فتضعنا في مناخها، حزينين أو فرحين، راضين أو ساخطين، رافضين أو مشدودين بخيوط الإعجاب والإدهاش، أمّا من أراد الحفر عميقاً والسبر في أغوار قصيدة أبي شعر فله شأن آخر، فقصيدته كما أسلفت مركّبة متراكمة الطبقات على الصعيدين المعنوي والفنّي، وإن كنت سأقف هنا عند نقاط تثير الرغبة في استزادة القراءة، وتغري بالبحث والغوص عميقاً لاستخراج اللؤلؤ المكنون في ثنايا القصيدة، وأعماقها.
سيتمحور حديثي هنا عن نقطة بارزة ذات أثر بيّن في التفاعل مع النص الشعري بل والتماهي معه إلى حدود بعيدة، ألا هي عنصر (الإدهاش أو الدهشة)، التي ما إن يفتقدها النصّ الشعري حتّى يفقد ماهيته بوصفه أدباً، فضلاً عند فقدانه المتلقّي وجسورَ التواصل معه. والدهشة هي الأمّ التي انبثقت من رحمها الفلسفة، فكما يقول أرسطو: (إنّ الفلسفة وليدة الدهشة)، وكما أنّ ما دفع الناس في الأصل وما يدفعهم اليوم إلى البحوث الفلسفية الأولى هو الدهشة، فإنّه الأمر ذاته الذي دفعني وسيدفع كثيرين إلى الوقوف عند قصائد هذه المجموعة الشعرية التي يبعث غيرُ قليل من قصائدها على المُتعة، والإبهار، والمفاجأة، والتشويق، والتلذّذ عبر تحقيق المتعة الجمالية والفكريّة معاً، ومن ثمّ تحقيق التواصل الجيّد والمثير مع الشعر، وهو منتهى غاية الشاعر أو الأديب عبر فنّه، ولكي لا نبقى في الإطار النظري، سألج إلى الاستشهاد بما أدهشني في هذه المجموعة، وإن بشيء من الاقتضاب من غير التطرّق لمصطلح الإدهاش الذي يستلزم إثارة الإعجاب والتلذّذ الجمالي، ومفارقة السائد من القول فنيّاً ومعنويّاً، وكلّها ذات أثر تحريضي تحفيزي استفزازي للمتلقي.
أوّلاً: إدهاش التكثيف/ العنونة أنموذجاً:
يُعدّ العنوان أولى عتبات النصّ، ومفتاحاً من مفاتيحه الرئيسة، فهو يفضّ مغاليقه، ويساعد على سبر أغواره، فيشير ويدلّ ويوحي ويؤثّث لفهم مبدئي، واتّخاذ موقف من الديوان الشعري أو النص، ومن ثمّ فإنّ متلقي الكتاب يقف عند هذه العتبة وقفة المتفحّص المرتاب، فإمّا أن يغريه ويحرّضه على اقتحام عوالمه الداخليّة، وإمّا أن يحدث العكس، وإلى ذلك يذهب “كريفل”، حين يشر إلى أنّ “العنوان بمنزلة السؤال الإشكالي، والنصّ إجابة عن هذا السؤال”([1])، وإن كنت في هذه العجالة لا أنوي الوقوف عند التحقّق من هذا الأمر، بالقدر الذي أريد فيه تقليب أوجه الإدهاش في العنوانات.
فـ(سلاماً مواعيد قلبي دمشق)، عنوان المجموعة الشعريّة، يحتوي على ثلاث دالات رئيسة، هي: (سلاماً)، وهي دالّة توحي وتشير وتبعث برسائل اشتياق والتياع إلى وطن أثقلته الآلام والأوجاع والجراح، ولاسيّما أنّ المجموعة تحمل كلّ هذه الثيمات في ثناياها، ومقولاتها بكلّ المستويات.
فالسلام: هو سلام المغترب عن الوطن إلى وطنه المشتاق إليه.
والسلام: هو أمنية الشاعر لوطنه المثقل بالجراح والأوجاع بعودة الأمن والأمان.
ودمشق: هي المنادى البعيد القريب، الذي يحلّ عبر إحلالات دَلاليّة، ولفظيّة بعد جملة اعتراضية: (مواعيد قلبي)، وهو أمر يكشف حجم الالتياع والشوق إلى دمشق مرابع الصبا والعشق والذكريات، والقارئ للمجموعة سيجد أنّ الشاعر لا يفوّت مناسبة للحديث عن دمشق عبر ذكرها الصريح، أو عبر المعادلات المعنويّة المتنوّعة وإحداها الشاعر نفسه، هذا بالنسبة إلى العنوان الرئيسي، ولو تحسّسنا انتشار هذا العنوان في المجموعة على مستوى العنوانات الفرعية في المجموعة، لوجدناه حاضراً بقوّة، فدمشق تعادل القلب في القصيدة الأولى: (قلبي على قلبي احترق)، أي: (قلبي على دمشق احترق)، وتعادل (مواعيد قلبي) معاني الفداء والتضحية بالـ (أنا) في القصيدة الثانية (القول ما قالت دمائي)، وهي المعادل النفسي في قصيدة (قليل كثير) الذي يعكس لوعة الاشتياق في انتظار تحقّق الموعد (مواعيد قلبي)، لتستطيل فيها الساعات القليلة التي تفصل العاشق عن لقاء معشوقته دمشق…. إلخ من العنوانات الأخرى.
ومن ناحية أخرى فإنّ اعتماد “أبو شعر” على التكثيف والتركيز والتبئير في بناء عنواناته، على نحو يمكّنه من استيعاب تجربته بأقل عبارات ممكنة، مع إمكانية البث الإيحائي والترميزي والدلالي في فضاءات وأمداء واسعة، يعكس مهارة عالية في استخدام اللغة الشعريّة، وهو الأمر الذي حقّق الإدهاش في العنونة، فهي من جهة أخرى ومضات موجزة، تقترب من تحقيق وحداتها العضوية، والاستقلال بنفسها، ما دامت قادرة على إيصال الانفعال والرسالة بأقل عدد ممكن من الكلمات، بحيث يؤدّي حذف أي كلمة من كلماتها إلى تقويض أركانها كاملة، كما تؤدّي أي زيادة إلى زلزلة أركانها، وإدخالها في مجال المعهود من القول، وهذه العنوانات تمثّل ولو بصورة عكسية “النهايات الحاسمة التي تمثّل الذروة وصفوة القول في إحداث الدهشة التي تتكشّف عن خيال خصب، فتهزّ القارئ، وتستحوذ على إعجابه، وتمتعه بجماليّتها، وتهزّه بطرافتها ومفارقاتها”([2])، ومن أمثلة ذلك العنوانات الآتية:
قلبي على قلبي احترق – القول ما قالت دمائي – النبع يروي ولا يرتوي – هي نظرة أم ملاك الكحول؟([3])
ثانياً: الإدهاش بالتصوير – المونتاج السينمائي:
أدّى انفتاح النصّ الشعري المعاصر على الأجناس الأدبيّة الأخرى كالمسرح والرواية، والفنون المتنوّعة كالفنّ التشكيلي والسينما، إلى ولادة أشكال فنيّة جديدة كقصيدة المونتاج مثلاً التي استعارت أدواتها من مبدأ عمل المونتاج السينمائي.
ونعني بالمونتاج السينمائي ترتيب مجموعة من اللقطات السينمائيّة على نحو معيّن، بحيث تعطي هذه اللقطات – من خلال هذا الترتيب – معنى خاصّا،ً لم تكن لتعطيه فيما لو رُتّبت بطريقة مختلفة، أو قُدّمت منفردة، والمونتاج يعيد ترتيب المواد الخام وتركيبها بحيث يصبح لها دلالة خاصّة، وهي لا تتم وفق التسلسل الطبيعي للحدث، وإنّما وفقاً للأثر الذي يريد المخرج إحداثه في المتفرّج([4])
وقد تجلّى هذا اللون من البناء في قصيدة (القول ما قالت دمائي) ([5])، ويمكن تقصّي هذا التجلّي بدءاً من عتبة الاستهلال، يقول أبو شعر:
قانٍ كياقوتِ الأساطير اكتمالاً
فوق صدرِ الرملِ مرميٌّ ردائي
جسدي تبخّر في أتونِ النار بحثاً عن
رحيق الفجر عن لونِ الرجاءِ
كي أهديَ الأحبابَ ميلادَ الضياءِ
حيثُ السماءُ قريبةٌ من طهر عشّاقِ النقاءِ
حيثُ السماءُ بعيدةٌ عن نصل سكّينِ اتهامٍ بالخطايا،
عن زعافِ الحيّةِ الرقطاءِ…
ووقفتِ شمعةَ راهبٍ حيرى بمفترقِ الدروبْ…
لا ترجعي عن شارة الإعصارِ زنبقةِ الهبوبْ([6])
فالشاعر يعمد إلى ترتيب لقطات لأشياء متباعدة بغية إحداث تأثير نفسي في المتلقّي، فيبدأ بصورة ردائه القاني الممتزج بالدماء، ثم صورة الجسد المتبخّر، ثم السماء الصافية النقيّة نقاء طهر العشّاق، البعيدة عن أن تكون مكاناً للنفي والإقصاء، وهنا تبرز صورة الحيّة الرقطاء وفق المثيولوجيا، ثمّ الأنثى الحائرة المقترنة باستحضار صورة الراهب، كلّ هذا المزج والاقتران الذي تتداعى عبره إلى الذاكرة صور ومشاهد وأشياء متباعدة مختلفة تتراكم على مرآة النصّ، يستحضرها الشاعر من هنا وهناك بدءاً بالقصص القرآني وقميص يوسف، مروراً بالمثيولوجيا والأساطير والأفعى التي أغوت آدم، فصورة الجسد المتبخّر، والتبخّر المعادل للصعود والارتفاع، ومن ثمّ فالجسد هنا جسد الفادي الشاعر – المسيح الذي رفعه الله إلى السماء، ومن الأشياء الرمل المعادل للأرض العربية، ونصل السكّين المعبّر عن الوحشيّة، والشمعة المعبّرة عن الهداية فضلاً عن الإعصار والزنبقة…إلخ.
لا ينتهي الأمر عند حدود الأنا والآخر الـ(مع) المذكور صراحة: الأنثى – الحبيبة – الوطن – دمشق، والآخر الـ (ضدّ) المشار إليه عبر فعل القتل (قانٍ) والحرق (تبخّر)… إلخ، فضلاً عن المناخ الأسطوري، وعناصر اللوحة المرسومة بعناية عبر استحضار الألوان بصورة مباشرة/ الأحمر القاني- بياض الرمل- الحيّة الرقطاء بلونيها الأبيض والأسود/، أو عبر دوال توحي بالألوان من مثل: النار-الفجر-الضياء-السماء-الزنبقة، وكأنّنا أمام لوحة فنان صامتة، مؤثّثة بالألوان والأشكال والظلال والعتمة والنور، وكلّها معادلات تعكس علاقة الأنا بالآخر الـ(ضد) الذي يظهر عبر اللقطات الآتية:
فالباعة المتجوّلون
جاؤوا مع العصر المسيّج بالسبايا
والغنائم والقرونْ
يتراقصونَ مع الفؤوس
من حول قدرٍ هائلٍ تغلي به ماءُ الجنونْ
ويحاولونَ بأن تكوني فيه زُلفى للوليمةِ والطقوسْ
أحيوا حشوداً من رؤى أحقاد جيناتِ البسوسْ([7])
فآلة التصوير هنا تنتقل بنا ما بين مشهد قديم – معاصر، تعمل على المزج بين زمنين تجمعا في جغرافيا واحدة سورية – دمشق، فتعبر من لقطة إلى أخرى عبر استحضار الصورة الوحشيّة للإنسان غير المتحضّر، حامل الفأس إيذاناً بقطع رؤوس الضحايا أو القرابين من جهة، والصورة الآنيّة التي لا تقلّ قساوة أو عنفاً عمّا سلف، وهو ما يحدث في سورية من قتل وذبح وإرهاب تذكيه أحقاد وأطماع لا حدود لها.
والشاعر يأتي بهذه اللقطات ليضعنا في مناخ من الرعب، عبر إضفاء الحركيّة على المشهد الجنوني، لكنّ هذه الحركيّة ما تلبث أن تنتهي إلى لوحات مرعبة عناصرها الألوان والروائح والأصوات، وكأنّنا أمام مشهد سينمائيّ دمويّ:
اليومَ تتّحدُ الخرائبُ بالحرائقِ بالشواءِ الآدميِّ،
بأطهر الأجسادِ أشلاءً رهيفةْ
في لوحةِ السوريالِ ترسمُ قربها أحشاءَ جيفةْ
اليومَ يقضي البعضُ طوعاً ليسَ باسمِ الأرضْ
لا ليسَ باسمِ العرضْ
لا ليس باسمِ حقِّ اللهِ، بل باسمِ الخليفةْ
صخبٌ نعيقٌ زاعقٌ كتهشّم البلّور
أصواتٌ تحابي الأدعياءْ
يعلو بتهليلٍ من الكهّانِ عندَ تدفّقِ الياقوتِ من عنقٍ
ذبيحٍ ثمَّ يلهجُ بالدعاءِ([8])
عناصر الصورة ولقطاتها مجمّعة من هنا وهناك، يتآلف فيها ما لا يأتلف من المتنافرات، ويشتغل الشاعر فيها على إبراز المفارقات التصويريّة بغية إحداث الإدهاش الفنّي والمعنوي معاً، فالإنسان والطفولة المحترقة من جهة، وأحشاء الجيفة من جهة أخرى، تكبير المدّعي أنّه يقاتل باسم الله، ودعاء الضحيّة التي حُزّ عنقها تحت تهليل المهلّلين والمكبّرين في مشهد سورياليّ لا يحتمله عقل أو منطق.
لا شكّ أنّ الشاعر استطاع إحداث الأثر المطلوب في المتلقّي، عبر إظهار مشاعر السخط والغضب، لكن بصورة فنيّة بعيداً عن الخطابية والمباشرة التي لا ينجو منها الشعراء عادة لدى تناولهم قضايا الوطن، مستفيداً من الفنّ التشكيلي من جهة، ومن الفنّ السينمائي من جهة أخرى، وهو بذلك يُحدث الأثر المطلوب في المتلقّي، عبر تحقيق خاصيّة الإدهاش التي هي سمة الفنّ الناجح.
أخيراً: هذا غيض من فيض ما يمكن أن يُقال عن هذه المجموعة المغرية حقيقة بالحث والتقصّي واستقصاء الجماليّات الفنيّة والمعنويّة وعوالم الإدهاش والتحفيز والإثارة، وقد تعوّدنا ذلك عند الشاعر “أيمن أبو شعر”، الذي لا أستطيع إلا أن أقع في فخّ جماليّاته، والاستشهاد بإنتاجاته الشعريّة، بوصفه استطاع ومنذ وقت مبكّر جداً أن يرسم لنفسه خطّاً مختلفاً في فنّ القول الشعري، ويسهم بصورة ملحوظة في تطوير القصيدة المعاصرة.
المصادر والمراجع:
- أبو سمرة، جمال: بنية القصيدة الشعريّة عند فايز خضّور، الهيئة العامّة السوريّة للكتاب، دمشق، 2012م.
- أبو شعر، أيمن: سلاماً، مواعيد قلبي دمشق، الهيئة العامة السوريّة للكتاب، دمشق، 2018م.
- بو طيب، جمال: العنوان في الرواية المغربيّة وأسئلة الحداثة، دار الثقافة، الدار البيضاء، 1996م.
- زايد، علي عشري: عن بناء القصيدة العربيّة الحديثة، مكتبة ابن سينا، مصر الجديدة، القاهرة، ط4، 2002م.
([1])بو طيب، جمال: العنوان في الرواية المغربيّة وأسئلة الحداثة، دار الثقافة، الدار البيضاء، 1996م، ص199.
([2]) أبو سمرة، جمال: بنية القصيدة الشعريّة عند فايز خضّور، الهيئة العامّة السوريّة للكتاب، دمشق، 2012م، ص282.
([3]) أبو شعر، أيمن: سلاماً، مواعيد قلبي دمشق، الهيئة العامة السوريّة للكتاب، دمشق، 2018م، والعنوانات وردت في الصفحات 5-8-117-121.
([4]) انظر: زايد، علي عشري: عن بناء القصيدة العربيّة الحديثة، مكتبة ابن سينا، مصر الجديدة، القاهرة، ط4، 2002م، ص215.