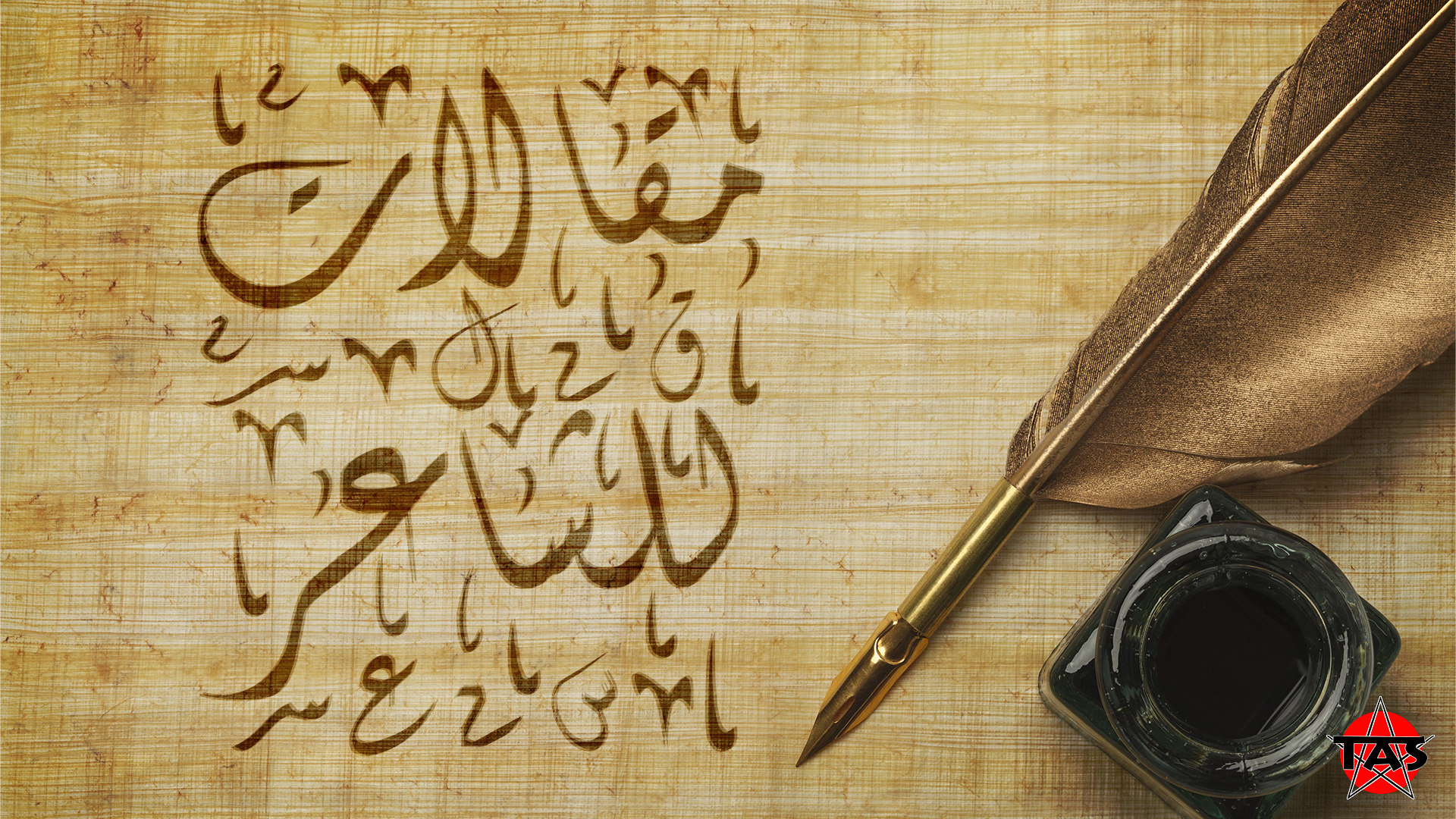د. توفيق سلوم
أميل إلى الاعتقاد بأن هذا العمل الشعري واحد من المنجزات الشعرية، سواء من حيث الأسلوبية التي تعتمد تكثيفاً لفن السهل الممتنع أو من خلال طبيعة البنى التصويرية التي توغل في العلائق الداخلية التي تتوارى بقدر ما نتوقف عند سطح الصورة وتنكشف بقدر ما نوغل مع الشاعر خلف ما يبدو للوهلة الأولى بأنه المدلول اللغوي المقصود في مرآة المعنى الظاهري..
في الثلاثيات التي بين أيدينا، يتبدّى لنا أيمن أبو الشعر في صورة جديدة تمثل نقلة جمالية في مسيرته الإبداعية، فقد ألفه قراؤه شاعراً ملتزماً، غنى الوطن والكادحين وفلسطين والقضايا الإنسانية.. أما هنا فأمامنا أنشودة (صوفية) يتسامى فيها نحو آفاق أرحب وأغنى جمالياً وفكرياً. تأتي هذه القصيدة استمراراً وتطويراً لتلك التقاليد الصوفية العرفانية التي أرسى أسسها الفكرية محيي الدين بن عربي، والتي عرفناها وتفاعلنا معها عبر أشعار ابن الفارض وجلال الدين الرومي أو حتى عمر الخيام. ولابد من الإشارة إلى أن الصوفية التي يتعامل معها هي تجربة محرقية وجدانية، جمالية فلسفية، تجسد ثالوث الحق والخير والجمال، بل إن الحق والخير عند الشاعر في هذه الثلاثيات إنما يتحققان تحديداً من خلال المنظور الجمالي مما يعطي مسحة خاصة لتمازج ما هو حق وخير بالمحرق الجمالي (الجوهر) كل ذلك من منطلق إنساني دون أن ينسى هموم الوطن والناس وكأنه يحلق في السماء لا هرباً من الأرض بل لكي يرصدها ويتأملها من نقطة أعلى تؤمن له رؤية أغنى وأشمل عبر -الرؤى- وأكثر جدوى لمسيرة الإصلاح والتغيير والجمال التي تكرس النقاء طفولة رائعة دائمة حتى عبر الحلم المهزوم:
أجمل الأشياء حلم
|
|
عند شباك الطفولة
|
فيه ألعاب وحلوى
|
|
ونشيد وجديلة
|
إن صعقت الحلم ربي
|
|
خل شباك الطفولة
|
هوامش حول الأسلوبية “الفخية”:
” الثلاثيات” ليست سهلة القراءة فهي كغيرها من الأناشيد الصوفية مصاغة بأسلوب مجازي رمزي يعطي للكلمة وللصورة مدلولاً متوارياً وراء المدلول السطحي الظاهري الذي يتراءى للقارئ المتسرع وكأنه هو المقصود ثم إنها مشبعة بالإيماءات الفلسفية والعلمية والأسطورية وبعض ظلال “الشطحات الصوفية” المطورة التي بدون معرفتها يتعذر فهم الصورة في هذه الثلاثيات والوقوف على مغزاها المقصود -عمقاً-.. وهنا ينبغي التنويه بأن للرمز والإيماءة في الشعر الصوفي مدى قد يحتمل أكثر من مدلول وتكون له تأويلات عدة لذا فإن قراءتنا الحالية لبعض المقاطع والمحاور ذات المنحى الفلسفي- والحياتي- لا يمكن أن تتنطح لأن تكون هي القراءة الوحيدة الصحيحة، خاصة أن الثلاثيات تطرح أسئلة كبرى على الإنسان ومدى تحقق إنسانيته كما يراها الشاعر في سموها العشقي الجمالي بحيث يمكن القول إن أيمن أبو الشعر يحاول ـ دون أن يدري ـ إضافة ظلال جديدة على المنحى الابداعي الصوفي برهافة الحس وبسالة الموقف والتألق الجمالي مع مسحة خفية منتوقدة من الحزن الشامخ
غن يا موال غن
|
|
رجع فرح وجع حزن
|
يبحث العشاق شجواً
|
|
فيك عن لون التمني
|
وأنا في الآه أذوي
|
|
باحثاً في الحلم عني
|
ما الذي دفع شاعراً “كأيمن أبي الشعر ” لخوض هذه التجربة المرهقة… سؤال هام يمكن أن تستشفه دراسات أخرى سواء من خلال تأثير التغييرات الهامة الانعطافية في العالم أو من خلال شذرات تبدت في العديد من قصائده تدل على وجود هذا الهاجس منذ زمن بعيد لدى الشاعر… ومع ذلك فنحن الآن تحديداً لسنا بصدد ذلك، ولكننا نشير عرضاً إلى قصيدة -منسية- في ديوانه الأول “خواطر من الشرق” “التسآل” التي تؤكد أن الأمر لم يكن مجرد مغامرة عارضة يقول مخاطباً صديقاً وهمياً يقنع بالخرافات:
فأرى على وجه العجوز مواعظاً
|
|
وترى التجعد في الجبين مقدرا
|
أو في قوله في قصيدته “نهج البردة”:ـ
فالقلب كعبة إيماني يطوف بها
|
|
حب الجمال وحب الحق نبض دمي
|
هذه الومضات تتراءى في العديد من القصائد والمجموعات الشعرية حتى التي طغى عليها الحس الإنساني.. والتي تحتاج كما ذكرنا إلى وقفة خاصة..
في رحاب وحدة الوجود:
منذ مطلع الثلاثيات يدعونا أيمن أبو الشعر لنطوف مع “شيخه” -وقد تقمص الشيخ والمريد في آن معاً- في بحار الكون التي لا حد لها ولا نهاية وكأنه يفتح كتاب الكون والحياة -الذي يعرفه كل منا بطريقته الخاصة- لقراءة متأنية، إنه يطالبنا أن ندخل معه في حومة التجربة “المحرقية” من جديد بحيث يمكن تقسيم الثلاثيات عموماً إلى ثلاثة محاور رئيسية:
1- قضايا الكون ومفهومه وفلسفة العلاقة مع الزمان والمكان -والحركة- وبالتالي الموت والحياة.
2- العشق والجمال والتوحد فيهما لمواجهة قسوة الوجود -الموضوعي الآلي- من هنا يبرز الحزن والموجدة كطريق للتطهر الروحي للوصول إلى الخلاص -عبر التألق-!!!.
3- العلاقة مع الحياة -الأرضية، اليومية- من خلال مفهوم التسامي ورفض المزيف الآني، وهنا يبرز منطوق الحكمة الإنسانية..!!
على أن هذا الكون- اللامتناهي واللامحدود- في آفاقه وصوره يتبدى للشاعر شيمة غيره من أنصار وحدة الوجود. منظومة متسعة تلف الأشياء الجزئية والفردية جميعها في عضوي واحد، وفي إطار هذه الرؤية “الواحدية” بحيث لا يبقى مجال لثنائيات مثل: “الذات- الموضوع”، “الإنسان- الكون”…
فالشاعر إذ يدرك وحدته مع الكون، وانسجامه الداخلي معه يذوب فيه ويفنى ذوبان القطرة في بحرها.. وفناء الجزء بالكل..:
بات قلبي عش طير
|
|
هام في كل اتجاه
|
إنني في كل صوت
|
|
يرسم الفجر صداه
|
في مدق الزهر طلع
|
|
في مدى الصبح نداه
|
حالة “الحلول” هذه تحتل الشاعر بحيث يستعيد تكوين العالم وعلائقيته ويتحد الوجداني والوجود إلى أن يلغى معه الشعور بـ “الأنا” بكون الذات المفردة شيئاً مغايراً أو مقابلاً للذوات الأخرى وهو بهذا المعنى يصل في سموه إلى حالة “لا جسدية” من خلال الغوص أو التحليق من “الأرضي” إلى “اللاأرضي” بحيث يغدو هو غيره المتسامي الذي لا يعرف “ذاته الأرضية” أو لا يستطع الاعتراف بها..
طرت لم أبرح مكاني
|
|
عدت نحوي لم أجدني
|
إلى أن يصل إلى حالة الفناء في المحبوب المطلق:
إنني قد صرت محواً
|
|
فيك يا محبوب صرني
|
وهناك أمر يحتاج كما يبدو إلى جرأة الاقتحام في التقييم. هذه التعابير الإشراقية لو جاءتنا في إطار المعطى الكلاسيكي الصوفي لكتبت عنها عشرات الدراسات.. لكن إشكالياتها الآن في أنها تقدم من شاعر معاصر.. بل وله تاريخ إيديولوجي محدد -سابقاً- لكننا مدعوون إلى مناقشة المنجز الإبداعي بغض النظر عن الأحكام المسبقة الجاهزة. فمع القائلين بوحدة الوجود يتخطى الشاعر بأناقة ملفتة للنظر ثنائية:
“المحسوس- المعقول”، “الواقع- الحلم”، “عالم الملك- عالم المثال”.
كما يسميها الإشراقيون من مفكري الصوفية، فالتجربة “الواحدية” تخترق الهوة الفاصلة بين هذه المقابلات وتمد جسراً من أحد العالمين إلى الآخر بحيث يعود الشاعر في رحلته الكونية. مؤكداً هذا “المعطى الهام” عبر الحلم “المنام” وعليه بصمات واقعية من آثار العالم الآخر المتوحد معه..
غارقاً في الحلم كنت
|
|
حين طيف بي ألم
|
قبلتني ثم عضت
|
|
ختم رح فوق فم
|
ونأى الحلم ولكن
|
|
فيم فوق الثغر دم
|
إن الواقعي والخيالي يتوحدان في حقيقة المشاعر إذن، والمفارقة هي إلى أي مدى تعايش “الواقعي” برفض أو تجاوز يجعله هامشياً، و”الخيالي” بتوقد يجعله واقعياً بالنسبة للذات المعايشة.
إن الشاعر منذ البداية يدفعنا للوقوف أمام وحدة الوجود دفعة واحدة عبر التساؤل الخفي الذي يطرحه المدخل حيث يأخذ العالِم الشيخ الجليل بيد المريد في رحاب الكون:
طاف بي شيخي بحاراً
|
|
وعلا بي للمجرة
|
والشيخ هنا هو الحكمة والمعرفة والخبرة وكأنه ينطلق من المفاهيم الأفلاطونية التي تحث على البحث عن المعرفة الأمر الذي يتكرس في رصد صورة “مثل” أو صورة الحياة في العالم العلوي حين يقلم الشيخ “المعرفة” أغصان النجوم المكفهرة بقدر تناميها في -الأرض- إثماً.. لكن المهم هو أنه بتصوير أسطوري يرصد النتيجة فحين تهوم الأنوار حول “الشيخ” يتقمصه الشاعر هنا -قصداً- إنهما قد وصلا حدود -المطلق- وسرعان ما تتكسر الرغبة بواقع الإمكانية فالسعي إلى المعرفة المطلقة مرهونٌ بإمكانية الوصول إلى الحقيقة المحدودة -النسبية-:
قلت لو جئنا حدود
|
|
المنتهى لاسطعت سبره
|
فبكى كالطفل غماً
|
|
وانحنى يقضم ظفره
|
قال ما طفناه دهراً
|
|
لم نبارح خرم إبره
|
وبالاتفاق مع الرؤية الواحدية للوجود التي تطابق بين “الإله” والعالم المأخوذ في وحدته واتساقه وقانونيته وجماله.. لا يبقى الكون مجرد انعكاس أو ظل، وإنما ترقى الأشياء وتتناغم لتغدو أجزاءً من الكل الإلهي:
هذه الأكوان ظلك
|
|
ما حدود المستظل
|
رمت بالظل وجودي
|
|
جزؤه كنه بكل
|
من زاوية كهذه يكف الإله عن كونه ذاتاً مفارقة متعالية على الكون الواقعي ، ومنتصبة فوقه، ليغدو حالة رائعة منبثة فيه ليحل في كل مكان ويتجلى في كل شيء رائع تجلياً لا يتبينه وينتظره إلا العارفون:
اصغ خلف الباب صوت
|
|
قال: لا همساً هناك
|
قلت: أهلاً يا حبيبي
|
|
قال: شيخي ما اعتراك
|
هاك ساح الدار قفر
|
|
قلت: عذراً ما رآك
|
بهذه اللقطة الذكية المتوقدة يضعنا الشاعر أمام نفس الإشكالية التي عبر عنها الحلاج حيث قال مخاطباً الإله:
وأي الأرض يخلو منك حتى
|
|
تعالوا يطلبونك في السماء
|
تراهم ينظرون إليك جهراً
|
|
وهم لا يبصرون من العماء
|
إنه الكل الكوني الذي يحضر في أي من أجزائه الفردية ولكن عامة الناس وبسطاؤهم لا يرون ذلك فهم يشاهدون الشجرة أو بعض الأشجار.. لا الغابة في كينونته
إن فهم الشاعر وقناعته بضآلة إمكانية الإنسان تجاه الكون “الذي يتوحد معه” حتى لتبدو “هذه الإمكانية” ليست أكثر من مساحة خرم إبرة مقارنة بمسافات ملايين السنين الضوئية لا تدفعه إلى العجز والتقوقع، وفي ذلك مأثرة عقلانية وروحانية كبيرة نسجلها للشاعر الذي سرعان ما يبدأ فتح رؤى جديدة لمفهوم وحدة الوجود حتى عبر المفارقات، فتوحد العلاقة حتى داخل الذرة ينعكس في مسار مئات ملايين السنين الضوئية مستخدماً أقصى ما توصل إليه العلم الحديث في اكتشافاته المذهلة:
مر نيترون شهاباً
|
|
في فضاءات كموني
|
كاشفاً بالعقل سراً
|
|
لم تسجله عيوني
|
أن أقصى سرعة في الكـ
|
|
ـون مقياس السكون
|
الشهاب في السماء عبر ملايين الكيلومترات في مساره، والنيترون داخل الذرة الذي لا تستطيع أعتى المجاهر تحديده إلا من آثار مساره يرصدان خفايا وحدة الوجود وتناقضها في مرآة واحدة عند الشاعر.
الشيء الهام في تصورنا أن الشاعر أوغل في التجسيد الجمالي لمفهوم وحدة العالم. فالمفكرون من الذاهبين مذهب وحدة الوجود لا يقتصرون على توحيد العالم والإله توحيداً ميتافيزيقياً “أنطولوجياً” يصور علاقتهما على غرار علاقة الكل بأجزائه بل يجسدون هذه العلاقة تجسيداً جمالياً، فالله جميل يحب الجمال كما يقول الصوفية بالاتفاق مع الحديث الشريف، وهو مصدر الجمال في الكون” فكل مليح حسنه من جماله”.. إنه يحضر في كل جميل، ويتبدى لكل عاشق في صورة معشوقه، فهو المحبوب في الحقيقة ومن هذا المنطلق يكتب عنه الشاعر في أقصى حالات الوجد العشقي حتى إنه يتحدث بقناعة تبدو كأنها “حقيقة كاملة” بلسان العاشق الذي جن وبات يرى أن الناس هم الذين جنوا وغدوا لا يرون الحبيب وهو “حقيقة” بجانبه بل ويسمعون مالم يقله أو يقلبوه!!! حسب تصور العاشق الذي يتقمصه الشاعر:
لا يراك الناس قربي
|
|
فالتصق بي كي يروني
|
قلت: إنك.. ثم جنوا
|
|
أقسموا أن قلت إني
|
وبما أني ذكرت موضوعة المداليل المتعددة والإيماءات الخفية أحب أن أشير هنا إلى إحداها، ففي البيت الأول (لا يراك الناس قربي .. فالتصق بي) المنطق التصويري والمعنوي يفترض أن يقول الشاعر (كي يروك) أو أن يقول في البداية (لا يراني الناس) لأن حجة عدم الظهور تتم لا في المجانبة (قربي) بل في حقيقة التوحد ومن هنا فإن قوله (كي يروني) مساو تماماً لقوله (كي يروك) الأمر الذي يؤكد مصداقية البيت الذي يليه.. الناس هم الذين جنوا وباتوا يظنون انه يتحدث عن نفسه عندما يتحدث عنه
استنطاق الطبيعة كأحد مؤشرات وحدة الوجود:
بالعين الجمالية ينظر الشاعر إلى العالم فيرى الحب مبدأً شاملاً سارياً في الكون كله، حتى في الأشياء ومظاهر الطبيعة التي يتصورها الناس -من غير العارفين- جمادات لا حس فيها.. هذا الأمر أو هذا المنظور حاوله شعراء كبار عالميون من مثل باسترناك وماندلشتام حين يحاول الأول التحدث بلغة أو مفهوم البلابل والمطر ويحاول الآخر استنطاق الآثار الغابرة، بل وحتى في أعمال بلوك شبه الصوفية في مفهوم أنثوية الألوهية والابتهالات الرمزية السرية ومحاولات الأكميزمية إلا أن كل ذلك ظل لدى هؤلاء الشعراء محاولة لتجسيد قناعات جمالية أيديولوجية من خلال الأعمال الإبداعية وبالتالي لم تستمر هذه الإبداعات على أهميتها لأنها كانت أشبه ما تكون بالمخبر الإبداعي ومن الواضح أن أيمن أبو الشعر قد استفاد من كل هذه الاتجاهات التي رصدها وكتب بنفسه عنها دراسات مطولة كتشظيات للموديرنيزمية في كتابه الضخم الشعر السوفييتي المجلد الأول لكن الهام هنا هو أنه تجاوز تلك الجسور التجريبية ودخل في حومة محرقية التجربة بحيث يتقمص أو يةحي بأنه يتقمص ولا يرصد خارجيا بل يستنطق الطبيعة بأنسنتها أو أنها تتداخل معه روحيا فتستنطقه فتطيبعه
فحين تتجرد شجرة الورد الدفلى وتتمدد إلى سطح نبع رائق يحلق الشاعر مع جمال الحالة متمازجا بها ناطقا باسمها دون تدخل خارجي
كان نبع يتعبد
|
|
قرب دفلى تتجرد
|
أوغلت في الماء حتى
|
|
لامس الردفين عربد
|
صاح يا عصفورتي
|
|
تيهي رفيفاً ثم غرد
|
ثقافة الشاعر لم تتحول إلى عبء يعقد أسلوبه الفني أو (سيرورته) بل دفعته إلى قفزة متألقة لعل جذورها تكمن في أنه يود أن يصل إلى الآخرين حتى عبر أنساق التلقي المتدرجة، فحين ارتقى فنياً لم يتخل عن الجماهير البسيطة بل ترك لها فسحة للارتقاء خطوة خطوة سواء في علائقية بنية الصورة أو في الدخول لاستيعاب المعنى العميق الذي بات يحتله تماماً، فالعشق الكوني السامي الذي ينادي به الشاعر يرتقي فوق ألوان المحبة المألوفة حيث لا غاية للعشق في المعشوق.. لأن القصد هو العشق ذاته، وبهذا الطرح الاقتحامي يقشط الشاعر الغبار عن قلوبنا وممارساتنا اليومية ويدعونا للدخول في المدى المطلق. حيث الارتواء يزيد العطشا
نحن لا نهوى حبيباً
|
|
إنما نهوى الهوى
|
وكؤوس الخمر زلفى
|
|
لدخول في الجوى
|
ذاك انّا مارتوينا
|
|
وهو منا ما ارتوى
|
لو حاولنا التأمل قليلاً لوجدنا أن أيمن أبا الشعر يضعنا أمام سؤال فلسفي في مفهوم العشق يتجاوز فيه إشكالية ابن الفارض -قليلا- لصالح العشق -لا- الذات العاشقة
يا نسيم الروض بلغ ذا الرشا
|
|
لم يزدنا الوِرد إلا عطشا
|
الإضافة الهامة هنا هي أن أبا الشعر جعل محوره العشق نفسه لا العاشق أو االمعشوق في جدلية العطش والارتواء.. لأن الارتواءعنده بتحقق جمالية (ارتواء) العشق ذاته العشق المعنى وليس جسوره وأدواته-العاشق والمعشوق- بحيث يبدو التوحد مع الكون جماليا عبر محرق الحب والموجدة أساسا لجمالية المشاعر الإنسانية المتعالية عن المألوف-التقليدي- المتجوهرة في كنه الجمال المطلق وبالتالي فهو متعال بقدر ما هو صادق وبسيط ..وفي الثلاثيات إشارات عديدة في هذا المجال
في الزمان والمكان
حاول شعراء عالميون كبار سبر أسرار الكون عبر رحلات خيالية كونية كابن عربي والمعري وفؤجيل ودانتي لكنهم بدأوا رحاتهم من الأرض إلى السماء في إطار رمزي حيث كان لمفهومي الزمان والمكان محور افتراضي تخييلي يخدم في نهاية المطاف المحاور الإبداعية لهذه الرحلة أو تلك لكن أيمن أبا الشعر انطلق برحلة معاكسة تبدأ من السماء وتنتهي بالأرض والواقع ومع ذلك فإن لمفهومي الزمان والمكان إشكالية خاصة في هذه الثلاثيات إذ لها موقع بالغ الحساسية لدى الشاعر في التعامل مع الكون والحياة، فالشاعر هنا يفرز ثلاثة أنساق للزمن، ويتعامل معها أيضاً بتمايز في الموقف منها باعتبارها (عنده) متمايزة في النوع الذي يتباين أو يتجانس مع درجات السمو الذي ينشده الشاعر:
1- الزمن الموضوعي -الشرطي- أي ما تعارفنا على اعتباره زمناً: الثواني، الدقائق، الساعات، الأيام.. الشهور.. السنين… الخ.. والشاعر يتعامل معه باعتباره زمناً حياتياً اجتماعياً مرهوناً بحركة الإنسان “فيه” وبالتالي يتعالى عليه لأنه زمن أرضي بحت دون أن يهرب منه باعتباره واقعاً.. لكنه يحاول أن يرصد منه تعريته بإدانته العلاقات والمفاهيم القائمة فيه حتى يغدو الإنسان الذي يستسلم لهذا الزمن الشرطي جزءاً من عفونته وفوضويته ومقاييسه.. ومن الرصد العلي يبدو ذئباً وضيعاً مؤنسناً في إنسان ذئبي وضيع..
فتحسست فرائي
|
|
واستعذت من البشر
|
2- الزمن المطلق وهو الغاية والمنتهى ويبدو وكأنه ذات مستقلة متعالية يعتبرها الشاعر تخييلياً وكأنها بعد خامس للكون (في حواراتي ع الشاعر أبدى اهتماماً خاصاً بهذا الأمر معبراً عن تصور مفاده أن الكون قد يكون خماسي أو سداسي الأبعاد خلافاً لنطق الأبعاد الرباعية وأن مثل هذا التناوب ـ حسب تصوره ـ قد يتيح أو يساعد على فهم شكل الكون وماهيته)، من هنا فإنه يدخلنا في مفهومه الأشمل لطبيعة الزمن بحيث يتلاشى ظل المكان وينعدم أمام سريان الزمن المطلق. ذاك أن الشاعر رغم عودته إلى المرشد لا يسقط في أحضان اللاأدرية أو اليأس المعرفي. ضمن منظار وحدة الوجود يغدو المطلق الكوني متجسداً في كل واحد من أجزائه بما في ذلك “انعكاسات” أو تكسرات الزمن.. وتتبدى الأشياء والأفعال بمثابة المرايا المتقابلة ينعكس واحد من أجزائها في كليتها، وتبدو “كمونادات” كل منها نسخة مختصرة من الكون “عالم صغير” يكثف غنى العالم الكبير…
كل سمت في مسار الكون
|
|
حد البد نهاية
|
فهو أهليج انحناء
|
|
يجعل الأسباب غاية
|
وهو بدء اللانهايات
|
|
انتهاء اللابداية
|
ويمكن القول إن ثلاثيات أبي الشعر تتجاوز النظرة التقليدية إلى المكان والزمان باعتبارهما شكلين (شاملين) مستقلين لوجود المادة فهو ينطلق من توحدهما معاً أولاً ومن ثم (بالمادة) كخاصية وهو ما يتفق مع ما توصل إليه العلم المعاصر في إطار النظرية النسبية ومن البديهي أن تناولاً من هذا النوع ليس عبثاً كشاعر كأين أبي الشعر الذي يرتكز إلى أرضية علمية مادية ومثل هذه المعطيات من منسياته لكنه ـ كما يبدو ـ يحاول قصداً بالمعنى الإيديولوجي ـ وعفوياً ـ عبر معاناته بالمنى الإبداعي التركيز على إعطاء أولوية أثيرية للزمان في السيرورة الكونية ويدعو إلى الأسى أن البعض انطلاقاً من المواقف المسبقة يتوقف عند الإطار الكلاسيكي للثلاثيات محاولاً مهاجمتها باعتبارها قريبة من الصيغة التراثية ناسياً أو متناسياً هذه الإشراقات أو الأطروحات النوعية الجليلة:
كل شيء من مكان
|
|
فهو بالأزمان فان
|
ليس من ماض وآت
|
|
كل وقت في الأوان
|
ليس من آن فآت
|
|
هو ماض بالتداني
|
كل بيت من هذه الثلاثية أطروحة تستحق التوقف حول مفهوم الزمان والمكان والحياة بينهما والأبيات الثلاثة معاً تشكل اتساقاً خاصاً يفضي إلى موقف يفتح باب التساؤلات الكبرى حول حقيقة الزمان والمكان سواءً وافقنا معه أم جافيناه. إن أيمن أبا الشعر في هذه الثلاثية ـ على سبيل المثال ـ يتعامل مع صورتين متقابلتين بآن معاً.. فالمسافر في القطار يستطيع للحظات أن يسعر بأن القطار واقف والأشجار والمباني هي التي تسير بعكس اتجاه القطار.. والشاعر سواءً عنى أم لم يعني يدفعنا إلى تساؤل إشكالي، هل يسير الزمن نحو الامام بعنى أنه ينطلق مما عشناه نحو اليوم الذي نعيشه في انتظار الغد الآتي الذي سنعيشه ونكاد أن نوافق لكه سرعان ما يقلب المعادلة في البيت الثالث من المقطع السابق ويقلب بالتالي جميع معطيات هذا التصور فتبدو (الحقيقة) من جديد في أن الغد الآتي هو الذي يقترب من اليوم الحالي ـ الآن المعاش ـ وسرعان ما ينطوي في غياهب الماضي الذي عيش.. والشاعر في الحالتين المتناقضتين اللتين سجلهما في هذه الثلاثية الإشراقية يقصد في الحقيقة شيئاً آخر تماماً لأنه يعول على السريان باعتباره الزمن المتحرك.، إنه كظل باهت للزمن المطلق الذي هو الجوهر.
وبهذه النظرة إلى الزمان يلتقي الشاعر مع كبار مفكري الصوفية الذين قدسوا الزمان (الوقت لذاته) مستندين إلى الحديث القدسي (أنا الدهر) والدهر عندهم آن دائم أو
(Nuncaeternitatia)
عند فلاسفة اللاتينية
3- الزمن الوصفي- بالاتساق مع المفهوم الأخير الذي يسمح بمد جسر أنطولوجي بين الزمان الفيزيائي الموضوعي والزمان النفسي المعاش، يصوغ صاحب الثلاثيات للكون” أو اللون الثاني من الزمان مجسداً” حالة “زمانية” كنهيه… بمعنى آخر أن الزمان الذي أعيشه كما يجب أن أعيشه هو الزمان التألقي -الذي يجب أن يعاش- في مغامرة الاختراق الذي يكثف معنى صيرورة الحياة بواقع سيرورتها المعاشة ألقاً كواقع، والمثال الذي يقدمه هو مجرد جسر يمكن أن ينطبق على آلاف الحالات لكنه يختار الأكثر تعبيراً عن ماهيتها التي يمكن أن يفهمها حتى الإنسان البسيط رغم عمقها الهائل.. فالسائس الذي يغازل ابنة السلطان وتسنح له الفرصة لمطارحتها الغرام يقول للسياف بعد انكشاف أمره:
حزَّ عنقي إنني
|
|
كثفت عمري في دقيقة..
|
لنلاحظ أن الموقف هنا من إنسان بسيط عادي سائس ليس إلا.. لكنه حين وازن بين لحظة جمالية رائعة وحياة عادية سخيفة اختار اللحظة “جمالياً” والشاعر في التعبير عن هذه الحالة يتعاطف ويدفعنا للتعاطف مع السائس الجميل في اختياره… ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن للشاعر تجارب عديدة يطرح فيها مفهومه عن الزمان “في هذا الاتجاه” في دواوينه السابقة بحيث يمكن القول بثقة إن ما تبدى في “الثلاثيات” في حومة رؤيا شاملة كانت له إرهاصاته الإبداعية والإنسانية عبر سبر أغوار الميثيولوجيا البشرية في مراحل متباينة من وعيها للكون..
يقول في قصيدة (وفوق الغمر لا رفات روح تعتلي إلا لهاثك) ـ
بلا شاط محيطك في طقوس العتم
ما اغتسل الشروق بحوض أفقك
ما تغاوى شعر شمسك في المغيب
لقد خدعتك رؤياك الأخيرة
فما شطرت (تعامة)ـ
أنت بدء وارتجاج في الظلام
وأنت ميلاد الهلام
وأنت شارات الهبوب
هو الزمن الزمن المميع من مياه من شحوب
بلا أضنيت عتمٌ.. لجةٌ.. ماء
وفوق الغمر لارفات روح
تعتلي إلا لهاثك
الجدير بالذكر أن الشاعر حتى هنا يحاول ان يعطي أولوية الاهتمام إلى الزمان، فتعامة هي آلهة العماء الاولى في المعطى المثيولوجي.. وفيه أن روح الله هي التي ترفرف فوق الغمر بعد البدء الأول ـ في البدء كان الكلمة ـ والشاعر حتى هنا يتمازج مع حالة الخلق هذه حيث يرصد لهاثه المستميت لبلوغ الحياة (وفوق الغمر لارفات روح.. تعتلي إلا لهاثك)ـ
هذه الشذرات التي كانت مبثوثة في العديد من قصائده حول ماهية الزمان ـ وخاصة في رثاء الجواهري، الحالم، المرصود، الحزن الألق، وحتى في الزمن الحلمي والتخييلي كما في الحلم في الزنزانة رقم سبعة والصدى ـ تأخذ مداها في الثلاثيات باندغام شامل يتجلى في انعكاس وحدة وصراع الأضداد في هذا لعمل الشيق
وحدة الأضداد وصراعها في الثلاثيات:
يبدو لي أن الشاعر حين احتلته الرؤى في “وحدة الوجود” -كنهاً- لم يعد يرصد أو يقصد أو ينوي أن يتخذ هذا الأسلوب أو ذاك بل غدا كالوتر المشدود حتى تخوم رهافة “الانقطاع” أو في برزخه مما أعطى الثلاثيات مجالاً فسيحاً للتحقق عبر العفوية المصاغة بأناة، ولو كان الأمر غير ذلك لخرجت عن كونها عملاً مثيراً..
من هنا فإن وحدة -وصراع الأضداد- يتبديان في الهيكل العظمي لهذا العمل وكأنهما الناظم الخفي لكل معطياته.. التي يمكن أن تبحث وتدرس كل على حدة.. ولعل من أسطع هذه الرؤى التي تتجانس مع المعطى العلمي تكثيفه لثلاثية سبق أن تناولناها في مجال آخر:
ر نترون شهاباً
|
|
في فضاءات كوني
|
كاشفاً بالعقل سراً
|
|
لم تسجله عيوني
|
أن أقصى سرعة في
|
|
الكون مقياس السكون
|
شبكة مكثفة من علاقات صراع الأضداد وتوحدها بآن معاً (النيترون ـ الشهب في السماء)، (ضآلة حركة النترون ـ والمسافة الهائلة لحركة الشهب)، (الكون المغلق ـ الفضاءات المفتوحة)، (انكشاف السر بالعقل ـ ثم الوصول إلى النتيجة المذهلة التي تتطابق مع العلم الحديث.. أن أقصى سرعة في الكون مقياس السكون) ولا يلبث أن يجسد هذا التوحد في صواع الأضداد عبر الغائية والسببية ولكن باسقاط ابداعي خاص يربط الكون كله بهذه المعادلة الصعبة على التلقي (العادي)ـ
كل سمت في مسار الكون
|
|
حد البد نهاية
|
فه إهليج انحناء
|
|
يجعل الأسباب غاية
|
وهو بدء اللانهايات
|
|
انتهاء اللابداية
|
ليس في الأمر أي تلاعب لفظي بل هو صميمية ما يرمي إليه الشاعر في استخدام إحدى نظريات تَشَكُل -أو شَكل- الكون “الإهليلجي” وهو لا يريد أن يستعرض عضلاته الثقافية وإلا لتوسع في هذا المجال، ولكنه يريد أن يظهر العلائقية السببية في الغائية عبر وحدة وصراع الأضداد. وإذا كان المحور في طرحه هو هذا الكون الإهليلجي الذي يجعل الأسباب غاية -ومن البديهي- العكس، فإنه يشير إلى أن علاقات الكائنات بالكون من حيث كونه كوناً مستثارة بتداخلها التوحدي في “أضدادها”.. وبالتالي ليس هناك من بداية أو نهاية مكانية وهذا شيء حساس جداً بالنسبة للشاعر الذي يعتبر الزمان المطلق كل شيء بما في ذلك المكان.. وفي ذلك إشارة خفية لقناعته بتعددية أبعاد الكون المطلق وعدم اقتصاره على الأبعاد الرباعية (الطول، العرض، الارتفاع، الزمن)ـ
من هنا فإن الشاعر يرفض -الزمان الشرطي- والعمر الشرطي بآن معاً وهو مقتنع تماماً بأنه “شباب دائم” لأن عشق حالة الدفلى وهي تغتسل في نبع الماء مماثل لعشق فتاة في الثامنة عشر من العمر لعلة أن العشق يتم بمفهومه السامي خارج حدود الزمن الشرطي ومن هنا أيضاً يبدو الموت الفيزيولوجي الذي لا يقتصر على من عاش عمراً مديداً بل قد يحتضن الأطفال كذلك يبدو أن لا علاقة له بالزمن المعاش بل إن البشرية اخترعت طقوسه بالغسل الذي يوحد بين الموت والولادة..
بلل الطفل ثيابه
|
|
بلل الكهل إهابه
|
غسلوا الطفل ليمضي
|
|
ماتحاً شهداً، رغابه
|
غسلوا الكهل ليمضي
|
|
يمنح الأرض لعابه
|
توحد الموت والحياة في طقس الغسل والعلاقة مع (الأرض) الواقع ـ النتح ـ والمنح إشكالية أخرى يتركنا الشاعر معها عبر التساؤلات الكبرى التي تحتاج أيضاً إلى دراسات عديدة.. ومن هنا فإن الرؤيا الواحدية للوجودلا تترك مجالاً لأضداد متناثرة إلا بقدر ما يمكن أن تتحول إلى (مونادات) أو تفاعلات متوحدة فهي تسعى لضم المتقابلات والتآلف بينها
تلك نزعة توحيد الأضداد التي عرفها الفلاسفة اللاتينيون تحت اسم:
(Coincidentia Oppositoru)
وجسدها مفكرو الصوفية في وصفهم للإله بأنه مجمع الاضداد
في المرآة الحياتية:
حين يدلف الشاعر إلى الحياة اليومية تظهر ظلال وحدة الوجود وصراع الأضداد عبر مسارات جديدة تكرس مفهومه السامي لتحقق وحدة الوجود أو ظلها عبر صراع الأضداد حتى في العلاقات الدنيوية بمعنى استمرار رؤيته لها من هذا الجانب، من هنا يبدأ بالتدخل نسبياً ولكن من “عل” أو من موقف “المتعالي” ولذا يجابه كل هذه الإشكالات بالتسامي والحزن والتساؤل المرير، ويختار لتكثيف هذه المفارقات بعض المسلمات ككرم حاتم الطائي، ويحاول الغوص إلى الجوهر..
أترى كان كريما
|
|
حاتم الطائي بذبحه
|
كي يباهي بالسخاء
|
|
أغرق الأوفى بجرحه
|
أم ترى كان الحصان
|
|
روحه صمتا بمنحه
|
إن الشاعر يريد أن يظهر حقيقة الموقف -جمالياً-
أولا أي كرم هذا الذي يدفع إلى ذبح “صديق العمر” للتباهي بالسخاء إن الكرم -كواقع جمالي- ينتفي حين يرتبط بفعل مرفوض جمالياً.. لأن ممارسة حالة جمالية شكلية تعارفية تتحول إلى حالة قبيحة بتناقضها مع “ضد مضمونها”
ثانياً إن هذه الصورة لا تلغي الجمالية عند الحصان في وفائه حتى حد الاستسلام للذبح.. وليس صدفة أن يصرخ الشاعر في قصيدته الحزن الألق واصفاً معاناة قلبه الصافح:
رَدَّه عن زفرة الأحقاد
|
|
عشقُ الأجمل المهزوم
|
|
لا النصرِ القبيحِ..
|
|
ولتكثيف المشهد الحياتي في المستوى الذي تم التهادن معه يختار الشاعر عادة “الضد” المضموني لتعرية “الخيانة” بمدلولها الواسع حين تكون مبرراتها المادية مقياساً “للشطارة- المتعارف عليها اجتماعياً- بالمعنى السلبي” أو طريقاً لنفي إنسانية الإنسان حيث يستخدم أحياناً المثال الرياضي المفضي إلى نتيجة الانعدام لما يمكن أن يحافظ على الإنسان إنساناً:
إنني أرثي لحاله
|
|
من غدا عبداً لماله
|
كان خدّاعاً وأدري
|
|
وهو لا يدري بحاله
|
كم تلاشى صار صفرا
|
|
عز عن معنى اختزاله
|
مقطع بسيط جداً.. لكنه عبر هذه البساطة يوغل إلى فارقة الضدين (المتسامي، الوضيع) المال حين يغدو سببا للخديعة (وهو كذلك في معظم الأحيان) يغدو صاحبه شبيهاً بالآلة الحاسبة التي لا مشاعر لها ـ إبان عد النقود ـ وبالتالي تتحول المشاعر ـ هنا ـ إلى أرقام وحين تكون العلاقة بين طرف هاجسه المشاعر لا تكون الخسارة في حجم الخديعة بل في أن الرابح مادياً هو الخاسر روحياً طالما عبر الخديعة وبالتالي لا يستطيع الطرف الروحاني الخاسر مادياً ـ المحب روحياً ـ حتى إنقاذ صديقه أو حبيبه الرابح مادياً ـ والخاسر روحياً ـ لأنهما أصبحا مختلفين بالنوع، وبمقدار التسامي الروحاني ـ العارف، الصامت ـ عن انخداعه بقدر ما يتضائل الرابح مادياً ليغدو أحد معطياته الرقمية، وبالتحديد ليغدو صفراً.. لا يمكن اختزاله لأنه تلاشى كإنسان
بهذا التكثيف يفتح الشاعر باب التساؤلات الداخلية حتى في مقاطعه البسيطة الحياتية. فالشاعر رغم شمولية الثلاثيات لم يستطع أن يتخلص من هواجسه الإنسانية والسياسية التي أفرد لها مجموعة من المقاطع من علياء الفادي الذي يرثي لحاله سجانه..
قد أتينا ومضينا
|
|
وهو باق كل حين
|
مجده في ظل قضبان
|
|
وفي سوط لعين
|
أيها الظل العجوز
|
|
أينا كان السجين
|
لا وجود للسجان دون سجين.. لكن السجين يمضي ويبقى السجان الذي يتعاطف معه الشاعر مبرزاً هذه الضدية إنه المُعَذِّبُ “المُعَذَّبْ” وهو الذي يرتج الأقفال لكنه يمضي حياته في السجن!!!.ـ
ويعمد الشاعر بذكاء لإظهار مفارقات الحياة اليومية (الدنيئة) إلى إعطاء المثل بمفارقة ضدية تناحرية المضمون.. فهو مثلاً لا يرسم خيانة مجرم لمجرم بل خيانة تقوم من صديق أو أخ منحه الطرف الآخر أقصى ما يمكن ان يمنحه قديس بحيث تبدو الصورة صفعة حقيقية (كارثية) فالصديق المخلص (حتى الجنون) ينقذ صديقه من حبال الشنق في مشهد مسرحي او سينمائي الطابع في ثلاثيتين متلاحقتين ويرصد الحالة القصوى للصمود إخلاصاً.. حيث يصور أن هذا الرجل قد اعتقل (بلا زمان أو مكان) وبدأت عمليات تعذيبه ليقر عن مكان صديقه ويسلمه، وحين يخشى أن ينهار ـ جسدياً ـ يمزق من جسده ما يمكن أن يرشدهم إليه حيث يفقأ عيونه ويقضم لسانه بعد هذا الرصد المشهدي يقدم الضد والنقيض ذاك أن ذلك الصديق ـ ليس في ظروف عادية بل في ظروف بذل صاحبه نفسه ولسانه وعيونه ـ يغتصب زوجة صديقه ويولي هارباً:ـ
خانه النذل وولى
|
|
سارقاً حتى حصانه
|
محاولة الشاعر إطفاء مأساته في فهم حقيقة هذا الجانب الحياتي (وليس كل الحياة كما سيتبدى معنا لاحقاً) تقربه من حدود المازوخية (تعذيب الذات) إلا أنه لا يقترفها بمعنى أنه لا يلجها منزوياً بل يستنهض عذاباته لكي لا تتهادن مع هذا الواقع رغم المعنى السطحي المعاكس الذي يلغيه ضده ـ التصويري ـ .. فهو لا يريد أن يهرب من آلامه في فهم الواقع بل يطالب ـ الصديق ـ الجديد ـ الكأس ـ أن يعمق من إحساسه بهذا الألم
نازفاً القاك سكباً
|
|
فاستعدني كي تريق
|
أنت نار أطفأت بي
|
|
ماء وجد كالحريق
|
التضاد الحقيقي يتصارع ليس من خلال معطيات البلاغة التقليدية “وإن كانت تعمق هذا الظل” -النزف، السكب، الاستعادة، الإراقة، النار، الماء، الإطفاء، الحريق- الأمر ليس مقابلة، بل إن الشاعر- عبر التصوير المضموني- لا يريد من الكأس أن تضمد نزفه -وإلا لغدا هروباً- بل أن توسع من نزفه لأنها الصديق الذي يفهمه” إن أتون عذابه في أن النار ذاتها تغدو شبيهةً بالماء مقارنة بوَجدِه الذي لم يمكنُ إطفاؤه -إلا بالنار- “لاحظوا تقابل الأضداد التي تقمصت “كُنْهَ” ضِدَّها.. ثم تقابلت لاستكمال وحدتها الشاملة – فالنار تُطْفِئُ- لعلةِ أنَ الوجدَ في اضطِرامِهِ يَجعَلُ النارَ شبيهةً بالماء فَتُصبِحُ قابلةً لأن تُطفِئ…!- لأن ماهية النار “الشراب” المتعاطف مع الشاعر هي التي تغدو -برداً وسلاماً على السيد القلب! الذي لا سبيل لإخماده..
في المحرق الجمالي:
قلنا منذ البداية إن الجمال هو الهاجس الأعمق الذي يتخذه الشاعر محور -المحاور- وهو يتعامل معه كمعطى -عصي- لا يقاربه إلا الجميلون.. وهو بذلك ينطلق من محورين: أن مدى روعة الجمال إنما يتحقق بكينونته الشاملة- لمن يحس هذا الجمال- وأن الجمال بحد ذاته كون رائع تتجلى طقوسه ذاتها -لذاته.
من هنا فإن الإحساس الجمالي الحقيقي هو اكتشاف ومعايشة تتماهى -أو تتمازج- فتخلق رعشة جمالية جديدة تحمل كنه الحالتين.. وهنا أيضاً يبدو صراع ووحدة الأضداد متمازجين ولكن بشكل سري خاص. إن الفنانين التشكيليين مثلاً أقدر على فهم هذا التجلي الرائع فهم يعرفون أن اللون الأزرق حين يمتزج باللون الأصفر يخلق اللون الأخضر، لكن الشاعر حتى هنا يركز على المدى الجمالي الخالص ففي إحدى الثلاثيات يلتقي طيران: أزرق وأصفر. ويمارسان الحب.. عندها..
فبدا في العش طير
|
|
أخضر لا غير يعبق
|
العشق عند الشاعر هو المدى والمنتهى- والتحقق الجمالي.. لكنه متعدد هلامي يحتوي كل شيء وقد يظهر من نقيضه ومن مفارقة الواقع المرتجى فهو الرجاء -في غير الحقيقة- وهو الحقيقة المطلقة التي لا يمكن أن تتحقق في الرجاء.. من هنا يرى الشاعر في حلمه -العشق الجمالي- حلماً يتكسر على صخور الواقع -اليومي- وطقوساً لا يمكن أن تتحقق إلا بالحلم… إنها مأساة الشعراء المبدعين عموماً فهم يرسمون الصورة المثلى التي لا مثيل لها في الواقع وبالتالي تهرب في محاولة التحقق بقدر ما تتكرس في المثال، وتستحوذهم المعاناة لأن الحبيبة -الواقع- منفية في المكان مما يدفع إلى مناجاتها في اللامكان.. حتى وإن تجلت في الزمان…
جن قلبي واضطرب
|
|
لما بضديه احترب
|
بالندى صرت احتمالاً
|
|
واكتمالاً باللهب
|
كم اتى لم تظهري
|
|
بل جئته لما ذهب
|
الشاعر – ربما دون أن يقصد – يكشف مأساة المبدعين عموما في تحقق العشق رؤى ، وانهياره واقعا .. وهو لم يجاف الحقيقة حين قال : لما بضديه احترب .. إنه يبحث عن – وهم ، خيال – نقيضه الواقع .. وعندما جاءت الحبيبة بعد أن ذهب تحقق المثال في البحث الدائم المستحيل وسقط تحققه في الواقع المعاش.. ولنلاحظ مرة أخرى حساسية استخدام صراع الأضداد – فالحبيبة تخلقت بالندى احتمالا .. والندى – خالق – واعد – لكنها اكتملت باللهب ، واللهب – ماحق – حارق – وبالتالي يصل إلى حقيقة رائعة جميلة تكرس هذه الوحدة المأمولة التي عليها أن تبقى كذلك بين الوهم المعاش كواقع – والواقع الذي نتوهم أننا نعيشه – كما يفترض الخيال – ويصل إلى حقيقة مريرة – جميلة:
نحن لا نهوى حبيباً
|
|
إنما نهوى الهوى
|
فكؤوس الخمر زلفى
|
|
لدخول في الجوى
|
ذاك أنّا ما ارتوينا
|
|
وهو منا ما ارتوى
|
الحبيب إذن مجرد جسر لتحقيق التألق وليس المبتغى لذاته ، من هنا لا يرتوي العشيق والمعشوق إن لم يرتو العشق ذاته ( وهو منا ما ارتوى ) وحين يلغي العشق العشيق والمعشوق يتحقق لذاته بذاته كما نوهنا سابقا ولذلك لا يرتوي المعشوق والعشيق إلا بارتواء العشق الذي هو الجمال عينه حيث يغدو احتلالا كاملا :
إنما العشق احتلال
|
|
بين وعد ووعيد
|
فهو في الكل عديد
|
|
وهو في كل وحيد
|
حين لا ترضى مريداً
|
|
ترتضي مالا تريد
|
مثل هذا المنطلق لمفهوم العشق في اتحاد تضاده هو الذي يجعل العاشق حرا بقدر عبوديته لتحقق العشق الذي اختاره :
مذ توضأت اختياري
|
|
ثم صليت ولوعي
|
بت سلطاناً بعبد
|
|
يرتجي أمري خنوعي
|
ليس من حر يداني
|
|
نبض قلبي في خضوعي
|